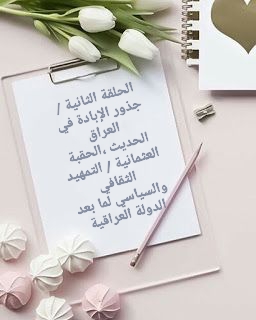الحلقة الثانية:
جذور الإبادة في العراق الحديث – الحقبة العثمانية: التمهيد الثقافي والسياسي لما بعد الدولة العراقية
بقلم :: نهاد الزرگاني
لا يمكن فهم الإبادة بوصفها لحظة دموية منعزلة، بل ينبغي النظر إليها كمحصّلة لمسار ثقافي وسياسي طويل، يبدأ غالبًا قبل ولادة الدولة نفسها. وفي السياق العراقي، فإن من أراد أن يقرأ جرائم الإبادة التي شهدها القرن العشرون، لا سيما في العصرين الملكي والجمهوري، دون التوقف عند الجذر العثماني، فإنه يغفل عن بنية عميقة تسكن في لاوعي السلطة والمجتمع معًا.
فالحقبة العثمانية لم تكن مجرّد فترة حكم تقليدي على أطراف الإمبراطورية، بل كانت معملًا تاريخيًا تم فيه تطبيع العنف، وتكريس مفاهيم “المركز” مقابل “الأطراف”، و”الطائفة المطيعة” مقابل “الفرقة الضالة”. وكان العراق آنذاك حقل اختبار لهذه المعادلات، حيث شُيّدت الإدارة العثمانية على أساس الريبة من التنوع، والخشية من التمرد، والشك في ولاء الجماعات غير السنّية أو غير التركية، فكان العنف أداة مركزية لضبط المجال.
المحور الأول: مركزية الدولة العثمانية وعلاقتها بأطرافها – العراق نموذجًا
في نموذج الدولة العثمانية، لم تكن السلطة تُمارس بوصفها عقدًا اجتماعيًا بين الحاكم والمحكوم، بل كانت علاقة هيمنة مركزية بين “السلطنة” و”الولايات”. وقد تجلّت هذه المركزية بشكل خاص في المناطق الطرفية كالعراق، الذي ظل لعقود طويلة يُدار كإقليم مشاغب لا يُؤمن جانبه، ولا يُؤتمن تنوعه.
لم يكن العراق بالنسبة إلى إسطنبول إلا هامشًا مهددًا بفتن طائفية، وقلاقل قبلية، وطموحات فارسية. من هنا، فإن تعامل الدولة معه لم يكن عقلانيًا، بل أمنيًا، فكانت الإدارة العثمانية تُنصِّب الولاة وفق معيار الولاء لا الكفاءة، وغالبًا ما يكونون غرباء عن السكان، أشداء في البطش، ضعفاء في الإصلاح.
اعتمدت السلطنة على سياسة “فرق تسد”، مستخدمة المذاهب والطوائف كأدوات ضبط:
الشيعة كانوا يُنظر إليهم بوصفهم خطرًا داخليًا محتملًا، بسبب ارتباطهم الرمزي مع إيران الصفوية في ذلك الحقبة من التاريخ .
اليهود والمسيحيون وُضعوا في خانة “أهل الذمة” بمفهوم متذبذب، يتغير بحسب المزاج السلطاني
العشائر استُعملت كقوة مسلّحة لقمع بعضها بعضًا، وتُركت في صراعات محلية منهِكة، تمنعها من التماسك.
وقد ظهر هذا بوضوح في وثائق الدولة العثمانية وتقارير الرحالة والمبشرين الذين زاروا العراق، مثل تقرير “جورج بوست” الذي وصف كيف كانت العلاقة بين الشيعة والدولة قائمة على الشك والخوف، إلى درجة أن الدولة كانت ترى أي نشاط ديني خارج المساجد السلطانية تهديدًا محتملًا.
أما في مدن مثل كربلاء والنجف، فقد مورست سياسات تهميش متعمدة، منعت التعليم الرسمي، وأبقت السكان في حالة عزلة عن القرار السياسي والاقتصادي. بل وحدثت حملات عسكرية ضد هذه المدن في فترات من التوتر، سجلها مؤرخون كـ”عباس العزاوي”، ومنها الحملة التي قادها داود باشا على كربلاء عام 1820، والتي قُتل فيها مئات من الأهالي.
المحور الثاني: إبادة الأرمن كأول اختبار للثقافة العثمانية في إنتاج العدو
منذ أواخر القرن التاسع عشر، بدأت الإمبراطورية العثمانية تواجه أزمة وجودية، تمثلت في تآكل مشروعها الديني وتفكك أطرافها، فاستعاضت عن خطاب “الأمة الإسلامية الجامعة” بخطاب قومي تركي جديد، بدأ يتشكّل مع صعود جمعية “الاتحاد والترقي”. كان هذا التحول إيذانًا بولادة آيديولوجيا ترى في الاختلاف خطرًا، وفي التعدد تهديدًا يجب القضاء عليه.
جاءت إبادة الأرمن (1915) بوصفها الذروة الوحشية لهذه الأيديولوجيا، لكنها لم تكن فقط مجزرة عسكرية، بل مشروعًا ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا ممنهجًا. فقد تمت شيطنة الأرمن في الإعلام العثماني، ووُصفوا بالخيانة، والتآمر مع روسيا، وتحوّلوا إلى “العدو الداخلي” بامتياز. أُعطي الضوء الأخضر للنخب، والعسكر، والقبائل المتحالفة، بل وحتى السكان المحليين، للمشاركة في الإبادة، إما عبر القتل المباشر أو عبر النهب والاستيلاء على الممتلكات.
ويُظهر الباحث تانير أكجام، في كتابه “القتل الجماعي وإبادة الأرمن”، كيف كانت الإبادة مؤسسية ومنظمة، تبدأ من القرار المركزي، وتمر عبر الجهاز البيروقراطي، وتُنفذ من قبل وحدات محددة أو بتنسيق مع قوى محلية.
لكن الخطير في هذا النموذج ليس في فعله فقط، بل في انتقاله الثقافي إلى المناطق الأخرى، ومنها العراق، الذي استُخدم فيه منطق “العدو المحتمل” بشكل مشابه، مع فارق الأدوات والأهداف.
هل تأثر العراق بإبادة الأرمن؟
بشكل مباشر، نعم. حيث:
سُجّل تواطؤ بعض العشائر الكردية والعربية في عمليات التصفية والنهب على حدود الموصل.ُعيد توزيع بعض الممتلكات الأرمنية المنهوبة داخل العراق (خاصة في الشمال).ظهرت في الإعلام العثماني الصادر في العراق نغمة الكراهية ذاتها.
جرى “تجريب” منطق الإبادة لاحقًا في التعامل مع جماعات أخرى، لا سيما بعد الاستقلال، وإن بصيغ قومية أو بعثية. الأهم من ذلك، أن الذاكرة المجتمعية في العراق لم تتعامل مع الإبادة بوصفها فاجعة إنسانية، بل بوصفها “حدثًا سلطانيًا” يخص السياسة، وهذا بحد ذاته إرث ثقافي خطير.
عند قراءة تاريخ العراق تحت الحكم العثماني، قد يظن البعض أن الفصول المظلمة قد انتهت مع سقوط السلطنة، لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير. فقد كانت بذور العنف التي زرعها العثمانيون، في جغرافيا العراق المجروح، قد نمت لتشكل واقعًا لا يزال يعصف بالبلاد حتى اليوم. تلك السياسات القمعية، وتهميش التنوع، بل وتحويله إلى تهديد، لم تقتصر على الحكم العثماني، بل استمرت في مراحل تالية من التاريخ العراقي.