class="post-thumbnail open-lightbox" href>
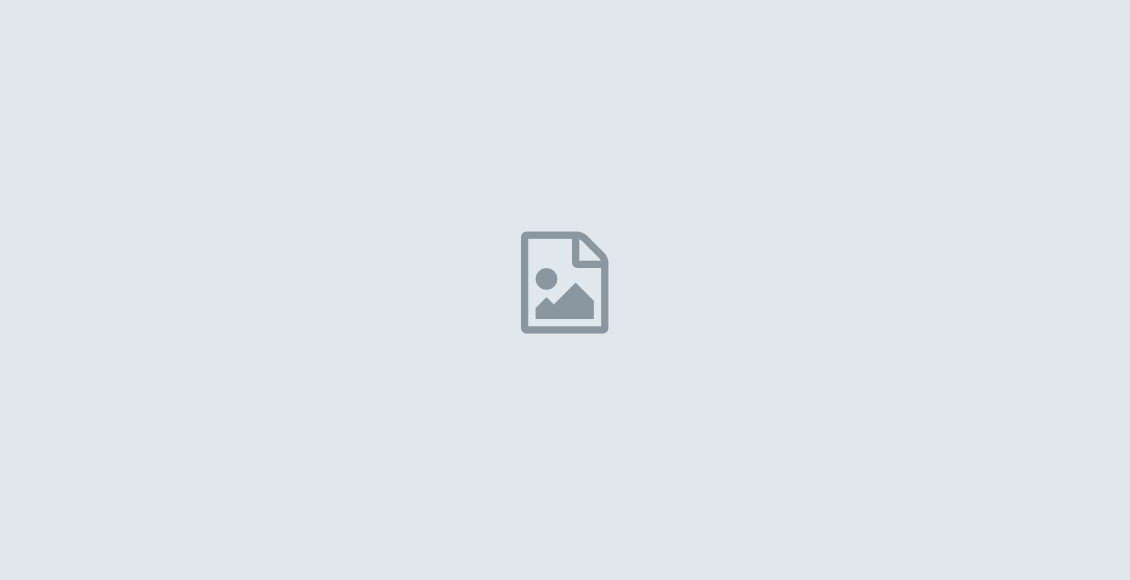
الحلقة السابعة: شمال العراق بين العثمانيين والاحتلال البريطاني – التركيبة السكانية، الصراعات، والطبقات الاجتماعية
جذور الإبادة في العراق الحديث
بقلم :: نهاد الزركاني
الحلقة السابعة: شمال العراق بين العثمانيين والاحتلال البريطاني – التركيبة السكانية، الصراعات، والطبقات الاجتماعية
المحور الأول: علاقة العثمانيين بالتركيبة السكانية في الشمال
كانت الدولة العثمانية تتعامل مع شمال العراق كمنطقة استراتيجية مهمة، لكنها في الوقت نفسه منطقة هشّة ومليئة بالتوترات العرقية والدينية. اعتمد العثمانيون سياسة “السلطان الحاكم” التي تقوم على إدارة المجموعات المختلفة عبر سياسة التوازن بين القوى المحلية، لا على أساس الاندماج أو التنمية.
ففي الشمال، حيث تداخلت القوميات والأديان، كان العثمانيون يحاولون استغلال هذا التنوع لتحقيق مصالحهم، فكانوا يشجعون بعض الجماعات على محاربة أو قمع الأخرى لضمان بقائهم في السلطة، ولا سيما في المناطق الحدودية التي كانت عرضة لتهديدات خارجية.
المحور الثاني: تهجير الأرمن وأثره الحضاري
وما يُغفل عنه في أغلب السرديات، أن الأرمن في الشمال العراقي لم يكونوا مجرد “جالية مقيمة” أو “أقلية دينية”، بل عقولًا منتجة ومبدعة، ساهمت في بناء عمران المدن، وتطوير الصناعات اليدوية، وتفعيل التجارة الداخلية، بل وحتى في نقل أساليب الإدارة الحديثة من بيئة الأناضول المتقدمة نسبيًا إلى بيئة عراقية أكثر بدائية في التنظيم.
لقد مثّل الوجود الأرمني وعيًا مدنيًا وحرفيًا راقيًا، وكانت مجازر 1915، بالتالي، ليست فقط تهجيرًا قسريًا، بل اغتيالًا للعقل المنتج، ومحاولة لنسف دورة اقتصادية ومعرفية مستقلة بدأت تنمو خارج إطار “الأمة العثمانية”.
إنها إبادة حضارية بامتياز، لا تختلف كثيرًا عن ما فعله صدام لاحقًا مع الكرد الفيليين أو ما مارسته داعش ضد الإيزيديين؛ حيث يكون استهداف الإنسان هو استهداف لذاكرته، لحرفته، لصوته، ولإمكانية أن يبني شيئًا مختلفًا خارج أيديولوجيا السلطة.
من جانب العمران، كانت صناعة الحرف والتجارة في شمال العراق دليلًا واضحًا على وجود عقل مدبر ينتج ويفكر، رغم الظروف الصعبة والتوترات السياسية.
المحور الثالث: الدين في الشمال – بين الطقس والسلوك
في شمال العراق، حيث تتعدد الانتماءات بين المسلمين (سنة وشيعة)، والمسيحيين (أرمن، آشوريين، كلدان)، واليزيديين، كان الدين حاضرًا بقوة في الوعي الشعبي، لكن حضوره لم يكن دائمًا أخلاقيًا أو إنسانيًا، بل اتخذ طابعًا طقوسيًا وقبليًا في كثير من الأحيان.
مارست الدولة العثمانية سياسة تسخير الدين كأداة ولاء للسلطان، لا كقيمة إصلاح أخلاقي. وقد عزّز ذلك وجود شيوخ الطرق الصوفية وزعماء القبائل الذين كانوا يُستخدمون لضبط المجتمعات المحلية باسم الدين، لا لترقيتها.
كان الدين غالبًا يُوظّف لتبرير الخضوع، أو لتأجيج الكراهية ضد “الآخر”، كما حدث حين وُظّفت فتاوى دينية ضد الأرمن والمسيحيين في سياق الحرب.
لم يكن الدين في تلك المرحلة محرّكًا للعدالة أو رادعًا للظلم، بل كان أداة طقوسية تُمارس يوميًا، ولكنها لا تُترجم إلى سلوك عادل أو تضامن إنساني.
المحور الرابع: النزاعات القومية والمذهبية في الشمال – بين الجذور العثمانية وتعقيدات الأقليات
لم يكن شمال العراق مجرد مساحة جغرافية متعددة القوميات والمذاهب، بل كان مسرحًا لتراكمات صراعية غذّتها السياسات العثمانية تارة، والتحولات الفكرية والقومية تارة أخرى. فالصراعات بين العرب والكرد والتركمان، أو بين السنة والشيعة، لم تكن وليدة خلافات عقائدية أو ثقافية بحتة، بل نتيجة تهميش متبادل، واستغلال مركّب من قبل السلطة المركزية العثمانية.
اتبعت الدولة العثمانية سياسة “التثبيت عبر التفكيك”، فدعمت زعامات محلية من قوميات أو مذاهب معينة على حساب أخرى، وأطلقت يد بعض القبائل الكردية في قمع المكونات غير المسلمة كالأرمن والآشوريين، بل وحتى اليهود، مستغلةً التوترات التاريخية لتثبيت سلطتها دون الحاجة إلى وجود فعلي دائم.
وكان لليهود حضور قديم ومتجذر في مدن الشمال، لا سيما في الموصل ودهوك وزاخو، حيث مارسوا التجارة والصيرفة والصناعات اليدوية، واحتفظوا بهويتهم الثقافية والدينية وسط بيئة معقدة ومشحونة. لم يكن اليهود في هذه المرحلة معزولين عن التحولات، بل جزءًا منها، يتأثرون بها ويؤثرون فيها، وقد تعرّضوا في فترات مختلفة إلى موجات من التضييق أو الشكوك، خصوصًا مع صعود الخطاب القومي المتوتر، وزيادة النفور من “الأقليات غير المسلمة”.
ومع دخول القرن العشرين، ومع تصاعد النفوذ الأوروبي في المنطقة وارتباط بعض اليهود بشبكات اقتصادية وتجارية ذات صلة بجهات أجنبية، بدأت تُنسج حولهم تصورات سلبية، ساهمت في شيطنتهم في الخطاب الشعبي، رغم أنهم لم يكونوا -في الغالب- جزءًا من أي مشروع سياسي.
الجدير بالذكر أن الحركة الصهيونية العالمية لم يكن لها في تلك الفترة (ما قبل الاحتلال البريطاني) حضور فعلي في العراق، إلا أن الوعي العثماني والخطاب الإسلامي الرسمي كانا يحمّلان يهود الداخل تبعات اليهود في الخارج، ما عزز من الشكوك والتمييز ضدهم، وجعلهم عرضة للازدراء أو التهميش، ولو بشكل غير ممنهج.
وهكذا، تضافرت التوترات القومية والمذهبية والدينية، لتشكّل بنية اجتماعية مضطربة، قاعدتها انعدام الثقة بين المكونات، وسقفها هشاشة الدولة، ما مهّد لاحقًا لتحوّل هذه التوترات إلى موجات عنف واضطهاد دموي، خاصة في فترات الانهيار الكبرى.
المحور الخامس: الطبقية الاجتماعية والفروق داخل المجتمع الشمالي
التركيبة الاجتماعية في شمال العراق لم تكن موحدة بل طبقية ومتعددة المستويات، ترتبط بشكل وثيق بالانتماءات القومية والدينية وأيضًا بالموقع الجغرافي.
أمثلة:
في كركوك، كانت عائلة البياتي من كبار العشائر العربية تملك أراضٍ واسعة ونفوذًا سياسيًا، تفرض الضرائب وتسيطر على الفلاحين من العرب والكرد والتركمان.
الأرمن كانوا طبقة حرفية وتجارية مهمة، يديرون معامل النسيج وصناعة الأحذية، ولهم مدارس خاصة لتعليم أبنائهم.
الفلاحون الكرد في القرى يعيشون في ظروف صعبة، يعملون بالزراعة ورعي الأغنام تحت ضغط ملاك الأراضي.
هذه الأمثلة تعكس تعقيد التداخل بين الطبقة والقومية والدين، وكيف كانت هذه التباينات تُستغل من قبل القوى الحاكمة.
الخاتمة
تاريخ شمال العراق في فترة ما قبل الاحتلال البريطاني هو لوحة معقدة من التداخلات السكانية، والصراعات القومية والمذهبية، والتفاوتات الطبقية التي شكلت إطارًا للصراعات التي أعقبت ذلك. لم تكن المجازر والتهجير مجرد أحداث عابرة، بل كانت تجسيدًا لسياسات منهجية تستهدف تفكيك النسيج الاجتماعي والحضاري لمنطقة غنية بتنوعها وبمساهماتها الحضارية.
الاعتراف بهذا التاريخ بعمقه، وبعوامل تعقيده، هو الخطوة الأولى نحو فهم واقع العراق المعاصر، وتأصيل مشروع وطني جديد يرتكز على العدالة الاجتماعية، والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، واحترام التنوع الإنساني.
إن دراسة هذه المحطات التاريخية بدقة وموضوعية تسهم في بناء ذاكرة وطنية تحمي العراق من العودة إلى دائرة الصراعات ذاتها، وتفتح آفاقًا للتعايش والتقدم المستدام.
