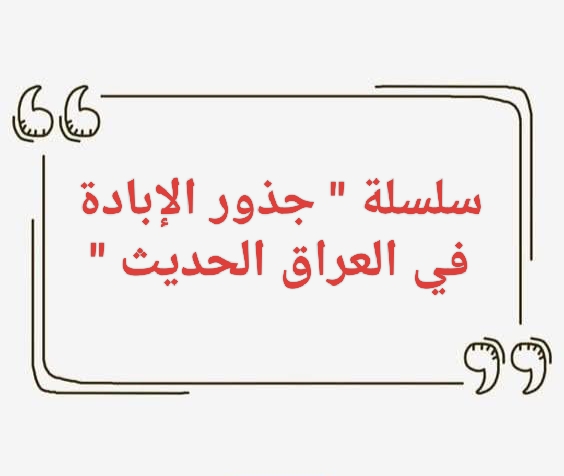سلسلة “جذور الإبادة في العراق الحديث”
بقلم :: نهاد الزركاني
الحلقة الرابعة: من حليف إلى هدف
المقدمة :
عبر سلسلة من الأحداث التاريخية والسياسية المعقدة، كان للعراق دور كبير في التفاعلات الإقليمية والدولية التي شكلت مسار تطور الأمة في القرن العشرين. من هيمنة الدولة العثمانية إلى دخول القوى الاستعمارية على خط التغيير، مثل بريطانيا، وتنامي الفكر القومي العربي على يد مفكرين ومثقفين عراقيين، كان العراق شاهداً على تحولات عميقة في هويته السياسية والفكرية. في هذه الحلقة، سنستعرض كيف تغلغل البريطانيون في العراق وكيف تحولوا من حليف للعراق إلى قوة استعمارية تحكمه من خلف الستار، لتهيئ الطريق لما سيعرف لاحقًا بـ الملكية العراقية التي ستساهم في قمع الأقليات وتشكيل أزمة سياسية داخلية عميقة في العراق.
—
المرحلة الأولى: استبعاد العثمانيين عبر الشركات البريطانية والتجار المحليين
في بداية القرن العشرين، كانت بريطانيا تنظر إلى العراق كأرض استراتيجية ذات أهمية جيوسياسية. ومن خلال الشركات البريطانية، لا سيما شركة نفط العراق (IPC)، بدأت بريطانيا في توجيه نفوذها الاقتصادي، ما ساعد في إضعاف السلطة العثمانية التي كانت تسيطر على المنطقة.
التجار المحليون في العراق، الذين ارتبطوا بالعلاقات التجارية مع البريطانيين، مثلوا حلقة وصل بين المجتمع العراقي والاقتصاد البريطاني، مما ساهم في زيادة النفوذ البريطاني في المنطقة. ومع مرور الوقت، بدأ البريطانيون في استثمار الثروات الطبيعية للعراق، خاصة النفط، الذي كان يشكل مصدرًا مهمًا للمصالح البريطانية.
وبذلك، بدأ التغلغل البريطاني داخل الاقتصاد العراقي يضعف النفوذ العثماني تدريجيًا، ويخلق بيئة ملائمة لتطوير فكر سياسي جديد. من بين هذه الأفكار، بدأ يظهر الفكر القومي العربي والفكر الماركسي الذي ساهم أيضًا في الصراع الفكري في الشارع العراقي، وهو ما سيساهم في خلق بيئة سياسية جديدة في العراق بعد انهيار الدولة العثمانية
—
المرحلة الثانية: دعم الفكر القومي وظهور النخب القومية
مع تزايد النفوذ البريطاني في العراق، بدأ البريطانيون في دعم الحركات القومية لتفكيك وحدة الإمبراطورية العثمانية. هذا الدعم لم يكن فقط سياسيًا، بل أيضًا ثقافيًا وفكريًا. عبر المؤسسات التعليمية والصحافة، بدأ الفكر القومي يظهر بقوة في العراق.
من بين المفكرين الذين ساهموا في نشر هذا الفكر كان ميشيل عفلق و ساطع الحصري، اللذان عملوا على تشكيل هوية قومية عربية بعيدة عن الهوية الإسلامية الجامعة. هذا الفكر القومي كان بمثابة أداة لتفكيك الوحدة الإسلامية، وهو ما كان يشكل تهديدًا للمصالح الغربية التي كانت ترغب في تقسيم المنطقة إلى كيانات ضعيفة.
أدى ذلك إلى صعود الأيديولوجيات القومية في العراق، الأمر الذي لاقى دعماً من المخابرات البريطانية التي سعت إلى استثمار الفكر القومي لتقوية نفوذها في المنطقة، ولتهيئة الطريق لعراق تحت وصاية بريطانية بشكل غير مباشر.
إلى جانب الفكر القومي، ظهر الفكر الماركسي الذي كان له دور أيضًا في العراق، بدعم من الاتحاد السوفيتي. الماركسيون العراقيون مثل فهد والزيداني تبنوا المبدأ الشيوعي وبدأوا في نشره بين الشباب العراقيين، مما خلق نوعًا من الصراع الفكري الذي لاقى دعمًا من القوى الكبرى لتوجيه بوصلة العراق بعيدًا عن الفكر الإسلامي.
المرحلة الثالثة: تأثير المخابرات البريطانية والسوفياتية في تشكيل الفكر القومي والماركسي
في ضوء التأثيرات الخارجية التي شكلت مسار الفكر القومي والماركسي في العراق، يمكن القول أن الصراع السياسي والفكري بين هذه التيارات لم يكن في الأساس صراعًا نابعًا من قضية محلية حقيقية تخص الشعب العراقي أو تطلعاته، بل كان نتاجًا لصراع القوى الكبرى على مصالحها في المنطقة.
الفكر القومي العربي الذي دعمته بريطانيا كان في الأساس جزءًا من سياستها الاستعمارية لتقسيم المنطقة إلى كيانات صغيرة تسهل السيطرة عليها. وكان الكثير من الشباب العراقي الذي تبنى هذا الفكر يظن أنه يناضل من أجل الاستقلال الوطني، ولكن في الواقع كان جزءًا من صراع بين القوى الغربية.
الفكر الماركسي الذي كان مدعومًا من الاتحاد السوفيتي كان أيضًا أداة أخرى في هذا الصراع. بالرغم من أن الشيوعيين العراقيين اعتقدوا أنهم يقاتلون من أجل العدالة الاجتماعية و التحرر، إلا أن السوفييت كانوا يسعون إلى استغلال هذه الحركات لصالح نفوذهم العالمي، مما جعل الصراع في العراق في النهاية صراعًا خارجيًا أكثر من كونه صراعًا محليًا يخص مصلحة الشعب.
نتيجة لهذا، الشباب العراقي الذين اندفعوا وراء هذه الأفكار، سواء كان قوميًا أو ماركسيًا، كانوا في الحقيقة يخوضون صراعًا سياسيًا خارجيًا بأدوات فكرية مستوردة، وليس من أجل قضية وطنية حقيقية تخص العراق أو تطلعاته في المستقبل.
المرحلة الرابعة: الفكر القومي كأداة للاحتواء والتحكم مع ظهور الملكية العراقية بعد الاستقلال عن بريطانيا، بدأت القوى القومية تسيطر على الحكم، ولكن بشكل يضمن نفوذًا بريطانيًا مستمرًا خلف الكواليس. وبدلاً من أن يكون هذا الاستقلال حقيقيًا، كان مجرد استقلال زائف يحفظ المصالح البريطانية في العراق.
ومع مرور الوقت، بدأت الملكية العراقية في قمع الأقليات مثل الأكراد والشيعة، الذين كانوا يشكلون جزءًا مهمًا من النسيج الاجتماعي العراقي. فقد كانت السلطة الحاكمة تتعامل مع هذه الأقليات وكأنها تهديدًا للوحدة الوطنية، مما أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية.
—
ضعف التأثير الإسلامي: أسباب الخلل
رغم أن العراق كان مجتمعًا إسلاميًا بشكل عام، إلا أن الفكر الإسلامي كان ضعيفًا في مواجهة التيارات الفكرية الأخرى مثل الفكر القومي و الفكر الماركسي. ويعود سبب ضعف التأثير الإسلامي في العراق إلى عدة عوامل رئيسية:
1. الاضطهاد الفكري: تعرض الفكر الشيعي خاصةً إلى اضطهاد فكري وتعذيب من قبل الدولة العثمانية. حيث كانت هناك محاولات ممنهجة لتقويض أي أثر فكري إسلامي يعارض السيطرة العثمانية. مما أدى إلى غياب مساحات حرة للمدارس الإسلامية في العراق.
2. غياب المدرسة الفكرية المتقدمة: لم يكن هناك مدرسة فكرية إسلامية متقدمة تدعم نظرية ولاية الفقيه أو توجهات فلسفية إسلامية متكاملة تتعامل مع التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه العراق في تلك المرحلة.
3. عدم تدخل المرجعية الدينية في السياسة: نتيجة الاضطهاد الذي تعرضت له المرجعية الدينية، وخاصة في مرحلة الدولة العثمانية، لم تكن هناك قوة إسلامية مركزية تستطيع التدخل أو توجيه الفكر السياسي، مما أتاح المجال لنشوء تيارات غير إسلامية.
—
خاتمة الحلقة الرابعة: من حليف إلى هدف
لقد مرت العراق بمراحل عدة في تاريخها الحديث، ابتداءً من تغلغل النفوذ البريطاني وصولاً إلى ظهور الفكر القومي الذي كان يشكل أداة لتفكيك الهوية الإسلامية الموحدة. ومن ثم، أصبح العراق في يد الملكية العراقية التي تحولت إلى أداة بيد القوى الاستعمارية، مما ساهم في استمرار القمع السياسي للأقليات وتفاقم الأزمات الداخلية في العراق.
—
التمهيد للحلقة الخامسة: الملكية في العراق ودور السلطة الحاكمة في قمع الأقليات
في الحلقة القادمة، سنتناول المرحلة الملكية في العراق، بدءًا من الملك فيصل الأول وصولًا إلى الملك غازي، وكيف كان النظام الملكي يساهم في قمع الأقليات، خاصة الأكراد والشيعة. سنلقي الضوء على الصراعات الداخلية التي نتجت عن هذه السياسات وكيف شكلت هذه الأزمات الواقع السياسي في العراق بعد الاستقلال، وصولًا إلى التحولات التي ستحدث في الستينات.