class="post-thumbnail open-lightbox" href>
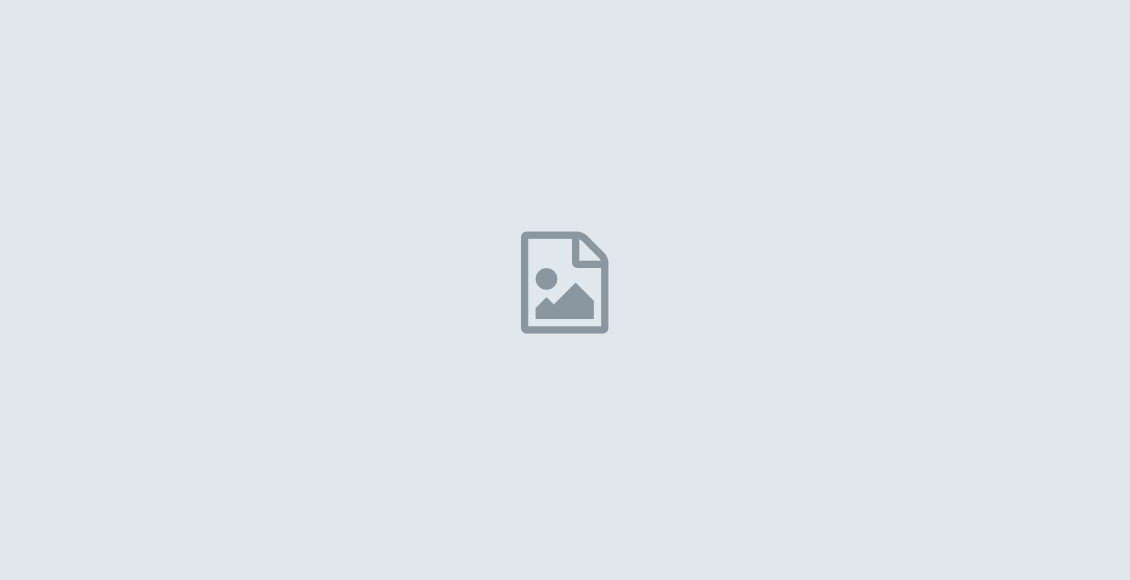
تحليل موضوعي لسلوك المسؤول العراقي: من الوطنية إلى الغنيمة
✍️ الكاتب : نهاد الزركاني
في كل دورة سياسية جديدة يتكرر السؤال القديم: لماذا يتغيّر المسؤول العراقي بشكل جذري بعد توليه المنصب؟ لماذا ينسى وعوده، ويضع المصلحة العامة خلف ظهره، ويغرق في الفساد المالي والإداري؟ هذه الأسئلة ليست مجرد اتهامات عاطفية، بل تستحق تحليلًا موضوعيًا يدرس الشخصية العراقية السياسية في سياقها الاجتماعي والتاريخي والثقافي، لنفهم كيف تتحول السلطة من وسيلة خدمة إلى أداة نهب وغنيمة.
المحور الأول: خلل الشخصية قبل وبعد المنصب
عندما ندرس ظاهرة التغيّر في شخصية المسؤول العراقي، نكتشف أنها ليست مجرد ((خيانة أخلاقية)) فردية، بل نتاج بنية اجتماعية وثقافية معقدة.
قبل المنصب، يحمل المسؤول في خطابه لغة مثالية مفعمة بالوطنية والدفاع عن الناس، وينتقد الفساد والمحسوبية ويُظهر نفسه جزءًا من الشعب. هذه اللغة ليست دائمًا كاذبة بالكامل. بل هي أيضًا تعبير عن طموح اجتماعي مشروع بالترقي والتأثير.
لكن المشكلة أن هذا الطموح لا يُترجم إلى مشروع متكامل مبني على قيم المواطنة والحوكمة. فالخطاب السياسي في العراق غالبًا يظل شعاريًا، يفتقر إلى برامج واضحة أو رؤية مؤسساتية. وحتى الناخبون أحيانًا ينجذبون إلى الخطاب الهوياتي أو العشائري أكثر من البرامج.
بعد الوصول إلى المنصب، تنكشف هشاشة هذا البناء القيمي. المنصب يُرى فرصة قد لا تتكرر. عقلية ((الفرصة)) تغلب عقلية ((التكليف)). تبدأ عملية تحويل السلطة إلى وسيلة لبناء الولاءات الخاصة، وترسيخ المصالح الشخصية أو العائلية أو الحزبية.السبب الأعمق هنا أن الدولة العراقية لم تُبنَ كمؤسسة خدمة عامة، بل تشكلت تاريخيًا كجهاز توزيع الريع والامتيازات. التقاليد السياسية والإدارية لم تتأسس على خدمة الشعب، بل على السيطرة عليه واسترضائه بالمكاسب مقابل الولاء.
إن هذا الخلل لا يُحل بالاتهامات الأخلاقية، بل يحتاج إلى إصلاح ثقافي يبدأ في الأسرة والمدرسة، وإلى أحزاب سياسية حقيقية، وإعلام نقدي، ومجتمع مدني مستقل، يربّي المسؤول على أن المنصب ليس حقًا مكتسبًا ولا غنيمة، بل أمانة ومسؤولية.
المحور الثاني: ضعف الشعور بالمسؤولية تجاه الشعب
أحد أخطر مظاهر هذه الأزمة هو ضعف الشعور بالمسؤولية تجاه الشعب. بالنسبة لكثير من المسؤولين، ((الوطن)) هو عنوان جميل في الخطب، لكنه لا يُترجم إلى التزام عملي.
في العمق، المشكلة في العلاقة بين المواطن والدولة، حيث لم يتطور عقد اجتماعي واضح، يحدد الحقوق والواجبات، ويجعل من المسؤول ((خادمًا عامًا)) لا ((مالكًا للسلطة)).
المسؤول يشعر أنه ((مانح)) للخدمة، لا موظف لدى الناس. يرى في نفسه وصيًا عليهم، بدل أن يرى نفسه مسؤولًا أمامهم. هذه العلاقة المختلة ليست قدرًا، بل هي نتاج موروث طويل من أنماط حكم استبدادية تعاقبت بأشكال مختلفة، من الاحتلالات الأجنبية إلى النظام الملكي، إلى الجمهوريات ذات الطابع الرئاسي والبرلماني، وكلها فشلت في بناء علاقة عقدية بين الدولة والشعب تقوم على الخدمة والحقوق المتبادلة، ما أبقى الدولة أداة للسيطرة والتوزيع الزبائني بدل أن تكون مؤسسة مواطنة حقيقية.
لكن من المهم جدًا ألا نُحمّل المجتمع كامل المسؤولية أو نوصمه بالاستسلام. المجتمع العراقي يملك وعيًا متناميًا وأصواتًا نقدية جريئة. الناس لا ينقصهم الذكاء أو الوطنية، بل ينقصهم إطار سياسي يتيح لهم المشاركة.
النقد الذاتي ضروري. المجتمعات التي تنهض تمارس النقد الذاتي كأسلوب بناء. في الصين مثلًا، كان النقد الذاتي أداة لتصحيح الأخطاء وتطوير التجربة. في العراق، يجب أن يكون النقد الذاتي جزءًا من مشروع الإصلاح، بحيث يعي المواطن مسؤوليته في اختيار المسؤول، مراقبته، ومحاسبته.
المجتمع ليس عبئًا، بل شريك في الحل. هو الذي يستطيع أن يفرض خطابًا صادقًا وبرنامجًا عمليًا. هو الذي يرفض التبرير الطائفي والعشائري للفساد ويبني ثقافة المواطنة والحقوق والواجبات.
المحور الثالث: الاقتصاد الريعي وأثره على العقل السياسي
الاقتصاد العراقي يقوم على ريع النفط، وهذه البنية الريعية هي جوهر الأزمة.
الدولة الريعية تتحول إلى ((كعكة)) يتنافس عليها السياسيون، بدل أن تكون مؤسسة إنتاجية تخدم الجميع. الموارد الطبيعية توزع من الأعلى، فتجعل العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة زبائنية: الحاكم يمنح، والمواطن ينتظر.
غياب الرابط بين الجهد والمكافأة يعمق ثقافة الاتكال. السياسي لا يفكر في تطوير الاقتصاد الإنتاجي، لأنه يحصل على الموارد جاهزة. والمواطن لا يضغط لفرض المساءلة، ما دام معيشه يعتمد على الحصة الريعية.
الاقتصاد الريعي يقتل المنافسة، يضعف الطبقة الوسطى المنتجة، ويشجع الفساد. في مثل هذه البيئة، تصبح الوظيفة العامة وسيلة للثراء السريع. كل مسؤول يرى المنصب فرصة للحصول على أكبر حصة من الريع قبل إقصائه.
المحور الرابع: الإرث المؤسسي بعد 2003
لا يمكن فهم سلوك المسؤول العراقي بدون تحليل التدمير المؤسسي الذي حدث بعد 2003.
حل الجيش، تفكيك المؤسسات، وضع نظام المحاصصة الطائفية – كلها أسست لبنية تشجع الفساد وتقسم الدولة حصصًا بين القوى.
نظام المحاصصة الطائفية ليس مجرد تقاسم سلطة، بل هو إطار مؤسسي للفساد. كل كتلة سياسية تعتبر حصتها الوزارية ملكًا خاصًا، توظف أتباعها، تتحكم في العقود، وتمنع الرقابة الحقيقية.
بهذا الشكل، غابت الخدمة العامة كقيمة، وحل محلها منطق الغنيمة. المسؤول ليس ممثلًا للدولة بل لحزبه أو طائفته، ويشعر أن الولاء لهؤلاء أهم من أي التزام وطني.
إصلاح هذا الإرث يحتاج إلى بناء مؤسسات وطنية عابرة للهويات الضيقة، قادرة على فرض القانون بالتساوي.
المحور الخامس: العامل الدولي والإقليمي
الفساد في العراق ليس ظاهرة محلية فقط، بل هو أيضًا أداة للنفوذ الأجنبي.
القوى الإقليمية والدولية تستخدم الفساد لشراء الولاءات السياسية، وتمويل الجماعات الموالية لها، وإضعاف القرار الوطني المستقل.
الشركات متعددة الجنسيات وشبكات التوريد الخارجية أحيانًا تساهم في تغذية الفساد عبر العمولات والصفقات غير الشفافة.
القوى الأجنبية تجد في ضعف المؤسسات فرصة لفرض أجنداتها، وتُبقي العراق سوقًا للمنتجات والعقود المشروطة سياسيًا.
محاربة الفساد ليست مهمة أخلاقية فقط، بل أيضًا مهمة وطنية لتحرير القرار العراقي من الابتزاز الخارجي. تحتاج هذه المعركة إلى شفافية، رقابة حقيقية، وتعاون دولي لا يخضع للصفقات.
المحور السادس: منطق الفساد بوصفه ضمانًا شخصيًا
أحد التبريرات الشائعة للفساد هو الشعور بعدم الاستقرار السياسي: المسؤول يعرف أنه قد لا يبقى طويلًا في منصبه، فيفكر: «يجب أن أبني نفسي سريعًا».
هذا التفكير قصير الأمد وخطير. عدم ضمان البقاء في المنصب لا يمكن أن يكون مبررًا للفساد. المسؤول الحقيقي يفهم أن مهمته بناء دولة تضمن الحقوق وتخدم الأجيال القادمة.
عليه أن يوسع أفقه ليشمل فكرة أن بناء الدولة يبدأ من بناء الإنسان القوي، المنتج، الحر. الإسلام يقدس الأمانة، والإنسانية كلها تقف مع هذه المبادئ.
المنصب ليس فرصة شخصية، بل مسؤولية أخلاقية وتاريخية. المسؤول الذي يفهم ذلك يترك بصمة إيجابية تبقى حتى بعد رحيله.
المحور السابع: الانقلاب في الشخصية عند لقاء القوى الأجنبية
ظاهرة أخرى هي التغير التدريجي في شخصية المسؤول عند التعامل مع الخارج. داخليًا يرفع شعار ((السيادة))، لكنه خارجيًا يقدم تنازلات.
هذا أحيانًا يعكس شعورًا بالنقص الحضاري أو ضعفًا في الهوية الوطنية.
السبب ليس فقط في شخصيته، بل في ضعف التقاليد الدبلوماسية، قلة الخبرة التفاوضية، وغياب الرؤية الاستراتيجية المستقلة.
إعادة بناء الشخصية الوطنية المستقلة تحتاج إلى تدريب دبلوماسي جاد، خبرة تفاوضية، ومؤسسات تفكر بمصالح العراق أولًا.
خاتمةوتحليل مستقبلي
ظاهرة تغيّر المسؤول بعد استلام المنصب ليست مسألة فساد أخلاقي فردي فقط، بل تعبير عن أزمة بنيوية عميقة:
غياب ثقافة الدولة المدنية.
ضعف روح المواطنة.
انهيار منظومة القيم العامة.
دولة ريعية محكومة بالولاءات الهوياتية.
إرث مؤسسي مشوّه.
تدخلات خارجية توظف الفساد أداة للهيمنة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن القضاء، بوصفه أحد أهم أركان الدولة، لا يجب وصفه بالفشل، بل علينا أن نساعده بتوفير الأدوات والضمانات ليؤدي دوره في إنصاف الناس وحماية القانون. المجتمع العراقي يرى فيه أملًا أخيرًا، وعلينا أن ندعمه بالإصلاح والثقة والرقابة.
الحل لا يكمن في الخطاب الأخلاقي فقط، بل في بناء نظام قانوني صلب، مؤسسات رقابية حقيقية، أحزاب سياسية برامجية لا زبائنية، وإعادة بناء الشخصية العراقية منذ المدرسة على قيم المشاركة، المسؤولية، احترام القانون، وممارسة النقد الذاتي .
